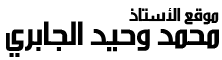كان دائماً يصيح بحرقة:«اللغة العربية في خطر،أدركوها قبل فوات الأوان» والخطر الذي يهدد اللغة العربية هو النتيجة الحتمية لتقاعس العرب عن أداء واجبهم تجاه لغتهم، وتنفيذهم لخطة الاستعمار الثقافي الساعية إلى إلغاء دورها الحضاري والفكري والثقافي، والقضاء على أداة التواصل بين الحاضر والماضي،
ولد الشيخ محمد الغزالي أحمد السقا في 5 ذي الحجة سنة 1335هـ, الموافق 22 من سبتمبر1917 م, في قرية “نكلا العنب” التابعة لمحافظة البحيرة بمصر,وسمّاه والده بـ”محمد الغزالي” تيمنًا بالعالم الكبيرأبو حامد الغزالي المتوفي سنة 505هـ .نشأ في أسرة كريمة مؤمنة,وأتم حفظ القرآن بكتّاب القرية في العاشرة,ويقول عن نفسه وقتئذ:“كنت أتدرب على إجادة الحفظ بالتلاوة في غدوي ورواحي، وأختم القرآن في تتابع صلواتي، وقبل نومي،وفي وحدتي، وأذكر أنني ختمته أثناء اعتقالي، فقد كان القرآن مؤنسا في تلك الوحدة الموحشة”. التحق بعد ذلك بمعهد الإسكندرية الديني الإبتدائي وظل بالمعهد حتى حصل على شهادة الكفاءة ثم الشهادة الثانوية الأزهرية, ثم إنتقل بعد ذلك إلى القاهرة سنة والتحق بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف, وبدأت كتاباته في مجلة (الإخوان المسلمين)أثناء دراسته بالسنة الثالثة في الكلية,بعد تعرفه على الإمام حسن البنّا مؤسس الجماعة,وظل الإمام يشجعه على الكتابة حتى تخرّج بعد أربع سنوات وتخصص بعدها في الدعوة والإرشاد حتى حصل على درجة العالمية سنة (1362هـ = 1943م) وعمره ست وعشرون سنة, وبدأت بعدها رحلته في الدعوة من خلال مساجد القاهرة, وقد تلقى الشيخ العلم عن الشيخ عبد العظيم الزرقاني, والشيخ محمود شلتوت, والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور محمد يوسف موسى وغيرهم من علماء الأزهر الشريف.
يتحدث الشيخ الغزالي عن لقائه الأول بالإمام حسن البنا فيقول:” كان ذلك أثناء دراستي الثانوية في المعهد بالإسكندرية، وكان من عادتي لزوم مسجد (عبد الرحمن بن هرمز) حيث أقوم بمذاكرة دروسي، وذات مساء نهض شاب لا أعرفه يلقي على الناس موعظة قصيرة شرحاً للحديث الشريف: (اتق الله حيثما كنت... وأتبع السيئة الحسنة تمحها..وخالق الناس بخلق حسن) وكان حديثاً مؤثراً يصل إلى القلب..ومنذ تلك الساعة توثقت علاقتي به.. واستمر عملي في ميدان الكفاح الإسلامي مع هذا الرجل العظيم إلى أن استشهد عام 1949م ” .
ظل الشيخ طوال خمسين سنة مرشداً للصحوة الإسلامية،ومدافعاً عن الإسلام في معاركه مع القوى المضادة، وظل يدعو إلى الفهم السليم في التعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي العريض، هذا مع الاستفادة من معطيات العصر النافعة في مجال العلوم والتقنية الحديثة.وترك ـ رحمه الله ـ مكتبة ضخمة من الكتب الفكرية،والدراسات الدعوية التي يجد فيها الدعاة بشكل خاص الفائدة الفكرية،والمتعة الوجدانية، وذلك لما تميزت به هذه الكتب من فخامة في الأسلوب، وبراعة في الإنشاء، وجمال في التعبير.جانب آخر برع فيه الشيخ وهو توظيف الأدب في خدمة الدعوة، سواء أكان ذلك في لغة الخطاب والمحادثة أم في مجال التعبير بالكتابة، وهو من الجوانب التي لا يحسنها كثير من الدعاة، ذلك أن الدعوة الإسلامية هي كلمة تقال، وفكرة تثار،فإذا أحسن الداعية التعبير عنها مع وجود عناصر الإخلاص والصواب والقدوة الحسنة آتت الدعوة أكلها بإذن الله تعالى، وأدت وظيفتها في مجال تغيير النفوس وبنائها.وقد وفق أيما توفيق في التعامل مع الكلمة وطرق أدائها،واختيارالوسائل الخطابية التي تناسب الناس في هذا العصرالذي تنوعت فيه الثقافات،وامتزجت فيه الأفكار،وأصبح التفاوت بين الناس واضحاً في جميع مستويات الحياة الفكرية والثقافية،والمتابع لكتابات الشيخ يلحظ أن جلها مطبوع بالطابع الأدبي،وإن كان موضوعها هو الفكروالعقيدة والدعوة الإسلامية،ويتجلى هذا الطابع الأدبي في جانبين:أولهما: توظيف النماذج الأدبية الراقية في خدمة الفكر الإسلامي.ثانيهما: اختيار الأسلوب الأدبي الجميل في التعبير والإنشاء.فكثيراً ما كان الشيخ يوظف النماذج الأدبية الراقية، كانت شعراً أم نثراً، في خدمة فكرة يريد بثها،وغرسها في النفوس،فهو يختاربحسه الأدبي ما يراه مناسباً من الموروث القديم ،ومن الإنتاج الحديث، ويمزجه بالحقائق الدينية ويعرضه في وقته ومكانه المناسبين، ليلائم به أذواق الناس ويلبي حاجتهم إلى القيمة الفكرية والمتعة الأدبية.وحين كتب كتابه «عقيدة المسلم» دعا إلى عرض العقيدة الإسلامية بأسلوب يجمع بين فخامة اللغة وجمالها، ودقة المعنى ووضوحه لتميل إليها النفوس، وتعلق بها القلوب،وقد حرص على تطبيق ذلك في كتابه هذا مخالفاً بذلك كثيراً من العلماء قديماً وحديثاً، ممن كانوا يعرضون العقيدة في قوالب جامدة،وأساليب عقيمة،بل كثيراً ما كانوا يقحمون خلافات أهل الكلام، واختلافات أهل الجدل حول مسائل العقيدة في كتبهم، فكيف يكون حال متلقي العقيدة من هذا كله؟ إنه مثل الصياد الجائع الذي يقضي نهاره في اللهث وراء الأسماك السابحة في النهر،وفي آخرالنهار يذهب بخفي حنين.
يقول في هذا ـ رحمه الله ـ: «إذا كان علم التوحيد على النحو الذي وصفنا ، فإن كتبه التي تشيع بيننا الآن فشلت في أداء رسالتها شكلاً ومضموناً، فمن ناحية الشكل لا معنى ألبتة لعرض علم ما في توزيع مضطرب بين متن وشرح وحاشية وتقرير،وفي لغة ركيكة، سقيمة الأداء، لغة تصور سقوط البلاغة العربية في عهد الحكم التركي» ثم يتحدث عن أهمية الأدب في هذا العصر، وعن وظيفته المفقودة عندنا حين نحاول عرض العقيدة وتقديمها للناس، في حين تجد أصحاب العقائد المنحرفة يعرضونها في أجمل صورة، يقول: «تطورالأدب في عصرنا هذا لا ينكر،وقد بلغ من تمكن المؤلفين في اللغة أن تناولوا الموضوعات التافهة فأخرجوها في ألبسة زاهية،ووجهوا ألوف القراء ـ بسحر بيانهم ـ إلى ما يريدون، فهل يبقى الكلام في العقائد حكراً على هذا النمط من الحواشي والمتون».وحين كتب كتابه القيم «مشكلات في طريق الحياة الإسلامية» تناول واقع الأدب ضمن المشكلات التي تعيق سبيل استئناف الحياة الإسلامية، ومن خلال عرضه المتميز لهذه القضية نستشف أنه يدعو إلى أمرين، أولهما: الدعوة إلى الأدب الإسلامي الحي الذي يدافع عن أمجاد الإسلام، المنبعث من قيم الإسلام ومبادئه.ثانيهما: الدعوة إلى رفض الأدب المنحرف بأشكاله كلها، ذلك أنه غاية يهدف إليها الاستعمار الثقافي، ودعاة الحداثة والتغريب.يقول في سياق حديثه عن جوانب النهضة الأدبية أيام «أحمد شوقي» و«حافظ إبراهيم» و«الرافعي» وغيرهم: «إن هذه النهضة الأدبية المباركة كانت تبنى على المهاد الأول، وتصل من أمجاد المسلمين ما أضاعه التفريط والغدر،وظاهرأن محافظتها على التراث،وتقديسها للقيم الدينية،وولاءها العميق للغة العربية،أن ذلك كله ثابت لا يتزحزح..لكن الاستعمار الثقافي لم ييأس، وعداوته للغة القرآن لم تفتر، إنه يريد القضاء على الإسلام،وأيسر السبل إلى ذلك القضاء على العربية وقواعدها وآدابها،وأظنه اليوم قد بلغ بعض ما يشتهي، فقد اختفى الأدب العربي الأصيل، وإذا وجدت كتابات بالحروف العربية فإنها وعاء لمعان مبتوتة الصلة بأصولنا الروحية والفكرية» فهويربط ـ كما هو ملاحظ ـ بين النهضة الأدبية المباركة التي شهدها القرن الماضي وبداية هذا القرن، وبين المحافظة على قيم الإسلام وتراثه الزاخر، حيث كان الأدب في مجمله محافظـاً على إسلاميته وجذوره الدينية، وبررفشل الاستعمارالثقافي في محاولته تجفيف الروح الدينية في ميادين الأدب إلى تمسك أولئك الأدباء بأصولهم الدينية،ومنطلقاتهم الإسلامية،ولم ينجح الاستعمارالثقافي في غايته إلا حينما جّرد الأدب من روحه الإسلامي، فأصبح أدباً لا أصل له، وغدا أدباً منحرفاً غريبا عن الثقافة الإسلامية، وهذا ما حفز الشيخ إلى الدعوة إلى رفضه فقال: «إذا كان الأدب مرآة أمة، ودقات قلبها، فإن المتفرس في أدب هذه الأيام العجاف لا يرى فيها ألبتة ملامح الإسلام ولا العروبة ولا أشواق أمة تكافح عن رسالتها،وسياستها القومية، وثقافتها الذاتية،ماالذي يراه في صحائف هذا الأدب،لا شيء إلا انعدام الأصل الهدف،والتسول من شتى الموائد الأجنبية، وحيرة اللقيط الذي لا أبوة له».إن الأدب المنحرف في أيامنا هذه هو فعلاً مثل اللقيط الذي لا أبوة له، بالإضافة إلى ذلك هو كالشجرة الخبيثة التي قد تغري الناس بأوراقها الزاهية، ولكن طعمها كالعلقم، وأثرها في الأرض وإن فشا سينعدم .كان الشيخ من أبرزالدعاة المنافحين عن اللغة العربية في هذا العصر، فقد كان دائماً يصيح بحرقة: «اللغة العربية في خطر، أدركوها قبل فوات الأوان»والخطر الذي يهدد اللغة العربية هو النتيجة الحتمية لتقاعس العرب عن أداء واجبهم تجاه لغتهم، وتنفيذهم لخطة الاستعمار الثقافي الساعية إلى إلغاء دورها الحضاري والفكري والثقافي، والقضاء على أداة التواصل بين الحاضر والماضي، الأداة الجامعة لهذا الشتات المتقطع للعاميات في الوطن العربي.ويرى الشيخ أن اللغة العربية تهان الآن بوسائل مختلفة:
أولاً: بالروايات التمثيلية التي تحكي عبارات السوقة، والطبقات الجاهلة، فتحيي ألفاظاً كان يجب أن تموت مكانها،وتؤدي إلى سيادة اللهجات العامية بدل سيادة اللغة الجامعة،هذا إذا علمنا مدى الطاقات المادية والبشرية التي تهدرمن أجل انتشارهذا النوع من الأدب العامي.
ثانيا: بالحديث عن من هم أهلٌ للقدوة من الزعماء وغيرهم الذين يحلولهم أن يتحدثوا بلغة تجمع بين الفصحى والعامية،ونحن ندرك مدى التأثيرالسلبي الذي يعود على المخاطبين عند سماعهم لهذه اللغة المضطربة، ومن البديهيات أن زعماء الدول المتحضرة اليوم من أحرص الناس علي مخاطبة الجماهير بلغة راقية تجلب الاحترام، ويرى الشيخ أن دعاة العروبة في هذا العصر هم من أعجز الناس عن الحديث باللغة العربية.
ثالثاً: وتهان العربية عند بعض أبناء المسلمين الذين يريدون الانقطاع عن الثقافة الإسلامية، ويرون أن الحضارة هي في تقليد الغربيين والحديث بلغتهم، والنظر إلى العربية على أنها لغة متخلفة لا تساير العصر.
رابعاً: وتهان أيضاً في مجال الأدب، حيث اختفى الأدب العربي الأصيل، وإذا وجدت كتابات بالحروف العربية فإنها وعاء لمعان مبتوتة الصلة بأصولنا الروحية والدينية.
مات الشيخ الغزالي بالطريقة التي طالما تمنّاها ودفن بالبقيع بين أهل الفقه وأهل الحديث ،فقد كان رحمه الله،يدعو طوال عمره ويقول "اللهم ارزقني الوفاة في بلد حبيبك المصطفى" وكان أهل بيته يستغربون وكذلك تلامذته ويقولون هذا صعب للغاية .في 9 مارس 1996، دعي للمشاركة في مؤتمر بالسعودية، حول الإسلام وتحديات العصر المنظم من قبل الحرس الوطني، في فعالياته الثقافية السنوية المعروفة بـالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ـ الجنادرية، وبعد تلقي الشيخ محمد الغزالي، الدعوة ترجاه تلامذته ألا يذهب لئلا يتطاول عليه أحد من الأدعياء،وكان الأطباء قد منعوه من السفرومن الانفعال ولكنه صمم على السفر.وألقى الشيخ كلمة خلال أشغال المؤتمر، وقام إليه أحدهم واتهمه بمعاداة السنة فانفعل وعلا صوته وهو يدافع عن موقفه من السنة، وكان آخر كلامه "نريد أن نحقّق في الأرض لا إله إلا الله" وأصيب بذبحة صدرية وخرميتا.وبتوصية من الشيخ عبد العزيز بن باز،مفتي المملكة الذي ربطته علاقة قوية معه، والذي يقول عنه الغزالي لما زاره "رأيت رجلاً يكلّمني من الجنة!"، نقل جثمان الشيخ إلى المدينة المنورة وحضرلدفنه الآلاف من المشيّعين من كل أصقاع العالم،يقول الدكتورزغلول النجارالذي حضر الجنازة "لما حضر جثمان الشيخ إلى المدينة فوجئنا أن هناك طائرات خاصة أتت من جميع أنحاء العالم، تقل ناسا كثيرين أتوا للصلاة على الشيخ الغزالي في المسجد النبوي، وازدحم المسجد عن آخره وخرجنا بالجثمان إلى البقيع وكنا ندفنه وما زال الناس في المسجد من كثرتهم".وتنقل مراجع مؤكدة، عن الشخص الذي يتولى دفن الأموات في البقيع قوله "إن صاحبكم هذا أمره غريب كلما شرعت في حفر حفرة أجد الأرض لا تلين معي، حتى جئت هنا ولانت معي الأرض بين قبري نافع مولى عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس صاحب المذهب المالكي"، ولهذا سمي "صاحب الميتة المخرصة"، فقد دفن -رحمه الله- بين أهل الفقه وأهل الحديث فكأنه يرد على من أعلنوا براءة أهل الفقه والحديث منه.